شرّح عالم النفس المصري/الفرنسي الشهير مصطفى صفوان في كتابه، ”لماذا العرب ليسوا أحراراً؟“ (عام ٢٠٠٦)، الأثر السلبي الناجم عن الهوة متزايدة الاتساع بين ضفتي المكتوب والمنطوق في العالم العربي أو بين الفصحى المكتوبة ولغة الحوار العامية التي تختلف، وأحيانا بشدة، من بلد إلى آخر.
هذه الهوة تساهم في استمرار وتعميق الظلم والفقر والفوارق المادية الضخمة في مجتمعاتنا.. هذه الهوة اللغوية هي أحد قواعد ودعامات السلطوية، وأقصد بالسلطوية، في مصر مثلاً، تركيز عمليات اتخاذ القرار في يد شبكات معينة ضيقة وتراتبية.. بعض هذه الشبكات تتمتع بسيطرة أكبر على السلاح وأدوات العنف مثل الجيش وأجهزة الأمن مثلاً، وبعضها الآخر يتحكم أكثر في السيطرة على الخطاب والممارسات الدينية أو الوطنية مثل الأزهر والكنيسة والقبطية وأجهزة الإعلام الممولة في أحيان متعددة من مصادر غامضة – وطنية أو أجنبية- وبعضها الثالث يتحكم في انتاج وتوزيع المعرفة العلمية مثل الخبراء -اللي بجد مش زي الخبراء الاستراتيجيين بتوع التوك شوز- في مجالات الطب والاقتصاد وغيرها.. شبكات السلطة هذه عادة تحرم فئات واسعة من الناس من المشاركة بصورة فعالة في اتخاذ قرارات تمس حياتها اليومية. لا يجب أن يحتكر الجنرال والشيخ والقسيس والخبير حق اتخاذ هذه القرارات ولغة الحديث عنها ولغتها هي ذاتها.
وتساهم هذه الهوة اللغوية بين الفصحى والعامية في غموض معاني مصطلحات أو مؤسسات مثل الديمقراطية والدستور والمواطنة وحقوق الإنسان، حيث تفتقر كل هذه المصطلحات لمقابل شائع مستخدم بالعامية يشير الى ممارسات ومبادىء محددة وواضحة يمكن ضرب أمثلة لها في الحياة اليومية، بل إن ما يراه الناس في حياتهم اليومية من التطبيق العملي لهذه المصطلحات كما تتلاعب بها النخب السلطوية يفقدهم أي اهتمام محتمل بها حيث لا سبب يدعوهم للأمل أنها قد تجعل حياتهم المادية أو المعنوية أفضل.
هل سيتغير الأمر لو فهم معظم العرب أن الديمقراطية ليست فقط مجرد انتخابات وإجراءات كما تقدمها النخب السلطوية (بل وتزورها أيضا إذا لم تعجبها النتائج)، بل إنها سعي دائم من أجل مشاركة جميع المواطنين في السلطة وحكم أنفسهم بأنفسهم. هل سيتغير الأمر لو فهمنا وصنعنا الدستور على أساس أنه القواعد الرئيسية التي يتعين أن تلتزم بها كل القوانين والتشريعات وأنه لا يمكن التلاعب بهذه القواعد بسهولة وخفة مثلما يجري الحديث في مصر الآن؟ هل لو فهمنا المواطنة على أساس أنها بطاقة عضوية في جماعة سياسية وجغرافية تمنح للعضو حقوقا وواجبات فعلية، سنفهم أنه أمر يمس حياتنا كل يوم بحق وليس شعارات فارغة فجة تنهال على آذاننا صراخا هيستيريا من مذيعات ومذيعين كل يوم؟
أزعم أن انحسار التأييد والاهتمام الشعبي، في مصر على الأقل، بالديمقراطية والدستور والمواطنة وغيرها من المفاهيم والمؤسسات الرئيسية للتطور السياسي الحديث، يعود في جانب منه إلى الترجمة السيئة لهذه المصطلحات من أصولها الغربية سواء في اللفظ أو في الممارسة وإلى قصر الخطاب في مجالات تهم كل الشعب على فصحى فقدت الأغلبية علاقتها بها، ولهذا لم ترتفع نداءات المصريين وشعوب عربية أخرى في انتفاضات ٢٠١١ من أجل الديمقراطية والدستور والمواطنة، بل صاحوا جميعا مطالبين بالعيش (الخبز) والحرية والعدالة وأن يسقط النظام الواقف بينهم وبين كل هذه الاحتياجات الضرورية في حياتهم اليومية. وعلى كل حال فالدستور والمواطنة وحقوق الإنسان والديمقراطية ما هي كلها إلا أدوات وسبل، لا غنى عنها في اعتقادي، من أجل تأمين الخبز والحرية والعدالة للناس.
تستفيد السلطوية (عسكرية كانت أم دينية) من عجز الناس عن بلورة مطالبهم وكشف تناقضات ونفاق الخطابات الوطنية والدينية السياسية. يرى الناس ممارسات السلطة اليومية حولهم من تعذيب وإهانة في أقسام الشرطة أو تواطىء من جماعات دينية (سلفية مثلاً) مع المؤسسات الأمنية ضد جماعات دينية أخرى (الإخوان مثلا) ولا تخدعهم كثير من ادعاءات النخب هذه حول تقوى الله وحب الوطن وتحيا مصر وكده. ما بيشتروش الكلام ده خلاص، لكن في نفس الوقت لا يجدون من يخاطبهم بلغتهم أو من يترجم إلى لغتهم قضايا معقدة أو من يساعدهم في نشر واستعمال لغة ومفردات تناسبهم وتعبر عنهم. ومن هنا كان سر النجاح الهائل لبرنامج “البرنامج” لباسم يوسف، ومن هنا كان خوف أصحاب السلطة والسلطان منه حتى تم إغلاقه خاصة بعد نقده اللاذع والشعبي لجهاز أدعت الهيئة الهندسية للجيش –آنذاك- أنه قادر على علاج المصابين بفيروس الالتهاب الكبدي سي الذي يعاني منه أكثر من عشر ملايين مصري – وهو الجهاز الذي اشتهر بأنه جهاز الكفتة ثم اختفى بعد ذلك هو وصاحبه اللواء إبراهيم عبد العاطي عن أنظار الإعلام.
لم تكن تهمة جاليليو جاليلي، عالم الفلك الإيطالي في العصور الوسطى، هي تحدي سلطة الكنيسة وإصراره على أن الأرض ليست مركز الكون فحسب، فقد كانت جريمته الثانية هي أنه نشر كتاباته باللغة الإيطالية خلافا لمن سبقه من العلماء الذين كتبوا بلغة النخبة، اللاتينية، وأفادت عريضة الاتهام المدفوعة من الكنيسة أن جاليليو كتب بالإيطالية لأنها “اللغة الأكثر ملاءمة لجذب السوقة الجهلة الذين تنطلي عليهم الأباطيل بسهولة.”، واعتقد أن ضعف القدرة على اجتذاب “السوقة والجهلة” هي النقص الرئيسي والخطير بين كل من يرغبون في الإصلاح أو الثورة في العالم العربي في مواجهة المعسكرات السلطوية (دينية أو عسكرية أو نخبوية فاسدة بأي صورة)، التي تقصف الجماهير يوميا بمدافع ثقيلة من برامج التوك شوز التلفزيونية التي بات العديد منها متخصصا في التهييج والكذب والخرافات ونظريات المؤامرات واللعب الفج على المشاعر الوطنية والدينية عن طريق مقدمي البرامج أو من يستضيفونهم من “خبراء”.
سيكون من الصعب أن تنتشر مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتلقى الدعم اللازم بين أغلبية مواطني البلدان العربية ما لم يستطيعوا التواصل مع هذه المفاهيم بلغة ومصطلحات وتعبيرات يفهمونها.. لم تظهر الديموقراطية في أوروبا قطعا بمجرد ظهور الكتابة بلغة عامية، بل مرت قرون بين ترجمة الكتب المقدسة ونشر الكتابات العلمية باللغات الشائعة من ناحية، وبين انتشار مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى. والعلاقة بين التطورين ليست سببية مباشرة، إذ هناك أسباب وملابسات أخرى كثيرة ساهمت في ظهور وتجذر ممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، إلا أن المرجح، كما يدعي صفوان، هو أن شجاعة كتّاب مثل جاليليو في النشر باللغة العامية فتحت الطريق أمام كتّاب على شاكلة جون لوك، ومونتسكيو وروسو الذين أسسوا بلغة مفهومة لمن يقرأون ويؤثرون على المجال السياسي كل المفاهيم الرئيسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة. كتابات هؤلاء المفكرين هي من صاغت في النهاية وثائق مهمة في تطور الأنظمة السياسية الحديثة ومنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن بعد الثورة الفرنسية وإعلان الاستقلال الأمريكي ودستور الولايات المتحدة.
إن المهمة الرئيسية للكتاب أو ما أُصطلح على تسميتهم بالمثقفين العرب الآن ليست قول الحق أمام سلطان جائر، فالسلطان المستبد أو الجنرال المنفوش الريش هو في حقيقة أمره أصم ولن يسمع كلام الحق لأنه لو سمعه وصبر عليه وسمح به، فقد يعني هذا أن تفلت منه السلطة تدريجيا. واجب الكاتب الأهم – كما يرى صفوان- هو مساعدة الناس أن يتكلموا بأنفسهم ويعبروا عما يريدون بطريقتهم وليس بالطريقة المتوقعة منهم من جانب الرئيس أو المذيع التلفزيوني الذي يمنحهم الميكروفون لثوان تكفي لتوجيه الشكر للرئيس أو صاحب السلطة أو يستعرضهم في مشاهد صراخ وغضب وعنف مما علبته التلفزيونات العربية وفرضته علينا كمشاهد معبرة عن الثورات الشعبية.
ولا يعني هذا أن الشعب، أو الفئات المُستغلة المُهمشة فيه، جالسة في انتظار المثقفين ليساعدوهم على بلورة أفكارهم وأحلامهم. يكفي فقط الإطلاع على كنز كبير من الأمثال والأغاني الشعبية العامية على مر السنين أو على كلام أغاني موسيقي المهرجانات مؤخرا لنرى كيف تتطور طرق التعبير الشعبية وتتحدى الأنماط التعبيرية للفئات المهيمنة وسلطويتها.
دون أن يعرف المثقفون التحرريون كيف يتحدثون مع الناس بلغتهم، بمفرداتهم، ويعملوا معهم من أجل التوصل لمفردات تعبر بشكل افضل عن تطلعاتهم وأحلامهم بدلا من سجون اللغة الدينية المحافظة أو الوطنية الجوفاء سيظل طريق المجتمعات العربية نحو التحرر من النظم السلطوية والقمعية السياسية والاجتماعية صعبا وضيقا تتردد في جنباته المظلمة أصداء صرخات من يقاتلون دفاعا عن تصورهم للدين أو فهمهم للوطن أو صراخ من يتعرضون للتعذيب في أقبية الأمن أو من يُقتلون ذبحا بين أيادي داعش. وما أكثر الصراخ وما أشد عجزه على شاشات وأوراق معظم منصات الإعلام العربية حتى أصبح الحديث القادم منها، مثلما يقول أهل السودان، “كلام ساكت” لا طائل منه، بل السكوت نفسه أكثر تعبيرا عنه.
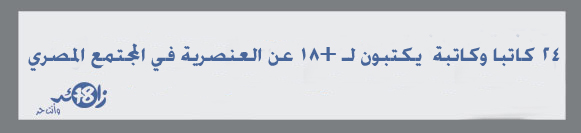

























 sending...
sending...