وضع التشريعات العقابية يحمل دوما حزمتين من التحديات، الحزمة الأولى هي تحديات تحقيق الأمن وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحزمة الثانية هي تحديات حماية الحريات الدستورية، وضمان صيانة الدولة لحقوق الإنسان من العدوان عليها أو الانتقاص منها سواء جاء هذا العدوان أو الانتقاص من طرفها أو من الغير.
وإذا كانت هذه التحديات تثير مخاوف عدة تصاحب عملية صياغة التشريعات في مراحل الاستقرار السياسي والاجتماعي في أي بلد حتى لو كان هذا التشريع صادرا من برلمان منتخب، فإن هذه المخاوف تتعاظم في المراحل الانتقالية التي تعقب الثورات أو تعقب تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة، وخاصة إذا صدرت تلك التشريعات من سلطة تنفيذية تجمع بين مهام سلطاتها ومهام السلطة التشريعية في ظل غيبة برلمان منتخب.
وإذا كانت مصر تمر بمثل هذه المرحلة الآن وقد صدر عشرات القوانين العقابية خلالها، فإن قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015 يعد واحد من أبرز تلك القوانين التي تكشف عن الفلسفة التشريعية التي تبنتها السلطة الحاكمة، فهل كانت هذه النصوص لمواجهة الظواهر الإجرامية فقط أم سعت من خلالها لمصادرة الحقوق والحريات وفرض قبضتها على المجال العام بزعم مواجهة الجرائم وضبط أداء الفرد والجماعة وحماية أركان الدولة والمجتمع.
لقد صدر هذا التشريع ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر في 15 أغسطس 2015، واشتمل على 54 مادة قسمت تحت ثلاثة عناوين (أحكام عامة)، (جرائم وعقوبات)، (أحكام إجرائية)، ويلاحظ في هذا التشريع عددا من النقاط البارزة:
في الأحكام العامة:
1- عرف (الجريمة الارهابية) بأنها(كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون) ليس هذا فحسب، بل أضاف (كل جناية أو جنحة) ترتكب باستخدام إحدى وسائل الارهاب أو بقصد تحقيق غرض إرهابي وهذا التعريف يسمح باعتبار أي جريمة عادية جريمة إرهابية -حتى لو لم يكن منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب- بزعم أن الوسيلة التي تم استخدامها إرهابية أو أن غرض تنفيذها غرض إرهابي.
2- وضع المشرع تعريفا (للعمل الإرهابي) حمل عبارات عامة ومطاطة شأن (الإخلال بالنظام العام) أو (تعريض سلامة المجتمع للخطر أو مصالحه أو أمنه) أو الإضرار (بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو بالموارد الطبيعية أو الآثار) أو منع أو عرقلة (الجهات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية.. أو المستشفيات.. أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها) وهو ما يفتح الباب –على سبيل المثال- لاعتبار أي تظاهرة أمام أي سفارة أو منظمة دولية احتجاجا على حدث ما، عمل إرهابي بزعم عرقلتها ومنعها من ممارسة نشاطها.
3- ثم عرف (الإرهابي) بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو (يحرض) أو (يهدد) أو (يخطط) في الداخل أو الخارج لجريمة ارهابية (بأية وسيلة كانت) ولو (بشكل منفرد) أو (يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك) أو تولى (قيادة) أو (زعامة) أو (إدارة) أو (إنشاء) أو (تأسيس) أو (اشترك في عضوية) أيا من الكيانات الارهابية.
4- وعرف(الجماعة الإرهابية) بأنها كل (جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة) مؤلفة (من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها) أيا كان (شكلها القانوني أو الواقعي) سواء كانت (داخل البلاد أو خارجها) أيا كان (جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها) تستهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الارهاب أو كان الارهاب (من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها)
والملاحظ أننا أمام أربعة تعريفات للـ (الجريمة الارهابية) و(العمل الإرهابي) و(الجماعة الارهابية) و(الإرهابي) اشتملت جميعها على عبارات فضفاضة وعامة يمكن تأويلها على أكثر من وجه، وأضحى من اليسير وصف أي حزب أو منظمة مجتمع مدنى أو جماعة سياسية أو اجتماعية بأنها جماعة ارهابية إذا اعتبر أن من بين أنشطتها ما يمكن وصفه (بالدعوة بأية وسيلة –داخل البلاد وخارجها- إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر).
فلو قامت أي نقابة عمالية أو مهنية أو اتحاد طلابي بالإضراب أو الاعتصام أمام المقار الحكومية يمكن توصيفها بأنها جماعة إرهابية، وبأن المشاركين فيها إرهابيون، يقوموا بعمل إرهابي، يستهدف تنفيذ جريمة إرهابية لـ (إلحاقها الضرر بالاتصالات) أو (احتلال أملاك عامة أو خاصة أو الاستيلاء عليها) أو (منع) أو (عرقلة) السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من القيام بعملها) أو (تعطيل المواصلات ومنع وعرقلة سيرها).
فالتعريفات الواردة بالقانون بما حملته من كلمات وعبارات تسمح بتجريم أي سلوك إنساني يتعلق بالعمل العام، رغم أن صياغة التشريعات لها معاييرها وضوابطها والتي أكدت عليها المحكمة الدستورية المصرية في أكثر من حكم بأن “النصوص الجنائية –بما تحمله من تجريم للأفعال ينبغي أن تكون نصوصاً منضبطة وواضحة ومحددة بصورة يقينية لا التباس فيها ولا غموض، وأن تتضمن النصوص تحديداً جازماً لضوابط تطبيقها، وأن تحكم معانى النصوص مقاييس صارمة ومعايير محددة تلتئم مع طبيعتها”[1] وذلك كله حتى لا تتحول تلك النصوص. كما أكدت المحكمة الدستورية العليا إلى “شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها“[2]
[1] حكم المحكمة الدستورية 58 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 5/7/1997والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 بتاريخ 19/7/1997
[2] راجع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 58 لسنة 18 قضائية دستورية
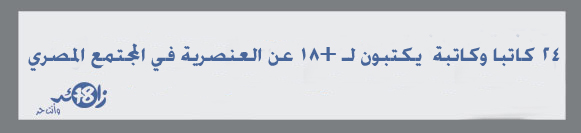























 sending...
sending...